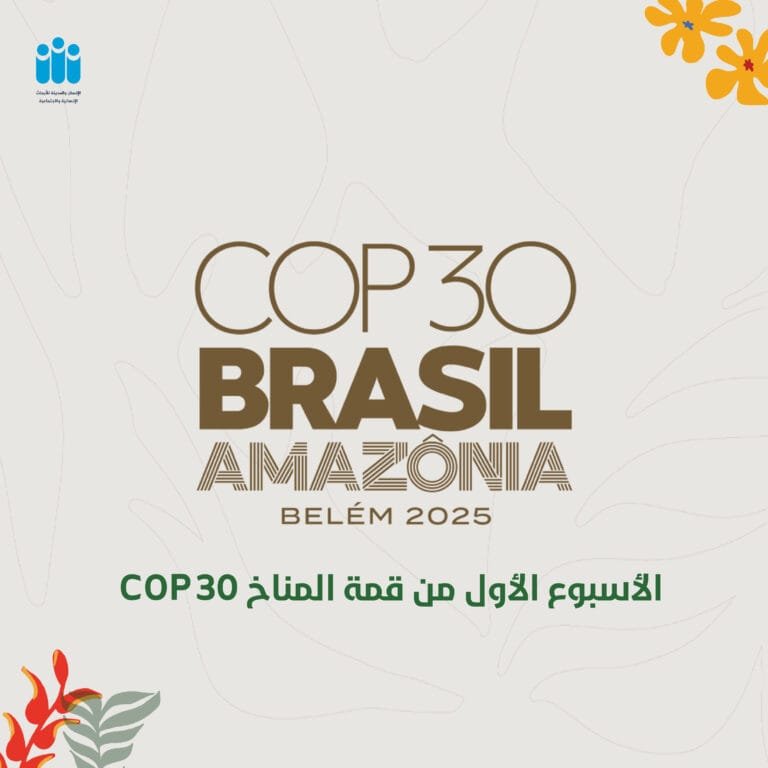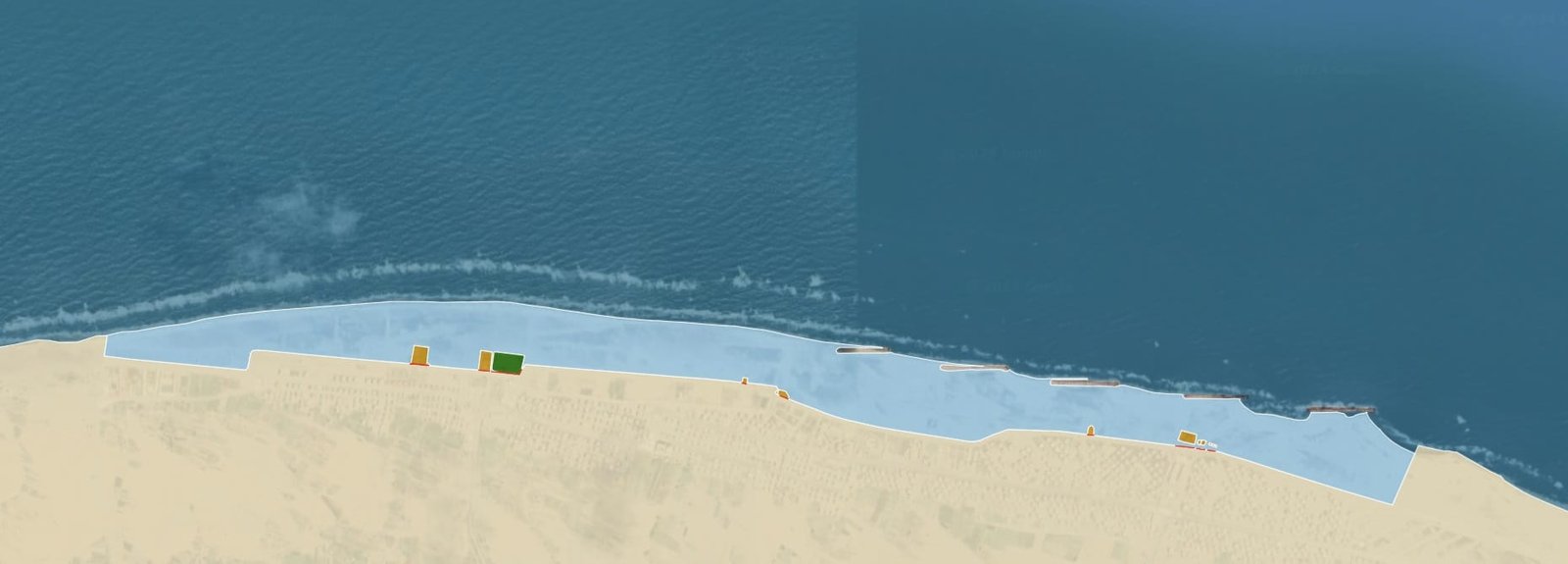مقدمة
يتجدد النقاش المجتمعي والقانوني في مصر حول معضلات قانون الأحوال الشخصية ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا مع التعديلات التي تضمنها مقترح مشروع القانون الجديد. ويأتي هذا النقاش في ظل إشكاليات قائمة ومتجذرة في المنظومة القانونية للأحوال الشخصية منذ قانون 25 لسنة 1920 ومرورًا بقوانين سنة 1925 و1943 و1952 وحتى دستور 1971 المُعدل سنة 1980، وانتهاءً بدستور 2014 وقانون الأحوال الشخصية الساري. سبق وأصدرنا ورقة بحثية عام 2022 بعنوان “معضلات قوانين الأحوال الشخصية المصرية[1]“، مسلطة الضوء على تحدياتٍ كبرى تواجه النساء في ظل هذه القوانين، سواءً على مستوى التطبيق القضائي أو الممارسات الاجتماعية، حيث تتضمن العديد من الثغرات التي تُؤثِّر على حقوقهن الأساسية بشكل يساهم في إدامة حالة من عدم المساواة بين الجنسين والقصور في تطبيق العدالة الأسرية فيما يتعلق بالعنف الأسري وضعف التمكين الاقتصادي وتوفير المسكن الآمن للنساء والأطفال، بالإضافة إلى قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستزارة، فضلًا عن الوصاية المالية والميراث والولاية التعليمية وحرية التنقل والسفر. ورغم الدعوات المستمرة لتعديل هذه القوانين، يظل التشتت التشريعي عقبة أساسية، حيث يُطبّق على المسلمين أحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة ودين الأغلبية، بينما يخضع المسيحيون لقواعد متضاربة تشمل لوائح خاصة وقرارات أخرى تمتثل للشريعة الإسلامية ومحاكم النقض والدستورية العليا، ويخضع غير المدينين بالإسلام أو المسيحية لنفس القوانين فضلاً عن عدم اعتراف الدولة بديانتهم من الأساس، ويسجلون في خانة الديانة منذ الولادة إما مسلمون أو مسيحيون، مما يؤدي إلى تضارب كبير في الأحكام القضائية بشأن القضايا الأسرية وقوانين الأحوال الشخصية.
إجراءات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد
كان من المقرر أن تنتهي لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من إعداد مسودة تعديل القانون في 5 أكتوبر 2022، إلا أن هذه الفترة مُدت حتى الانتهاء من المشروع كاملًا. وفي يناير 2025، أعلن رئيس اللجنة[2] الانتهاء من صياغة القانون الجديد الذي يتضمن 355 مادة مُوزعة على ثلاثة أقسام رئيسية: 175 مادة للولاية على النفس، و89 مادة للولاية على المال و91 مادة تخص الإجراءات وآلية تنفيذها، و60 مادة مشتركة في مجمل القانون بين المسلمين والمسيحيين متعلقة بالمسائل الإجرائية والتنظيمية فقط مثل الرؤية والاستزارة والنفقة دون المساس بأحكام الشريعة. كما سيتم تعديل عقود الزواج لكلا الديانتين، لتقديمها ضمن مذكرة إيضاحية إلى وزارة العدل. وفي 20 مارس 2025، أعلن وزير العدل[3] خلال احتفالية المرأة المصرية أن الوزارة تلقت كافة التعديلات وجاري إعادة ضبط مشروع القانون وصياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية يتكون من 13 مادة، وأنه قد شُكِّلت لجنة مختصة من الخبراء في قضايا الأسرة بموجب القرار رقم 3805 لسنة 2022، والتي بدأت عملها في 4 يونيو 2022 بتوصية من رئيس الجمهورية. هدفت اللجنة إلى إعداد مشروع قانون يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويحد من تراكم المشكلات الناتجة عن القوانين القديمة.
تمثيل غير متوازن في لجنة إعداد القانون
رغم أهمية وجود تعديلات تضمن حقوق الجميع وتعطي أولوية في سن تشريعات وقوانين تضمن حماية للنساء والأطفال وحقوق أولية وضرورية لهم، يعكس التمثيل النسائي في لجنة إعداد القانون خللًا واضحًا. فاللجنة تتكوّن من ثمانية قضاة ذكور مقابل قاضيتين فقط. وقد تلقت اللجنة 4733 مقترحًا، منها 2595 مقترحًا من الرجال، و2128 مقترحًا من السيدات، و10 مقترحات من بعض الهيئات والمؤسسات، ومقترحًا واحدًا من أحد الأحزاب السياسية. ربما يُظهر هذا بعض الهيمنة لوجهة النظر الذكورية في عملية صياغة قانون يُفترض أن يعالج مشكلات النساء وأطفالهن بالأساس.
بين القانون الحالي والجديد
أحد أبرز التعديلات في المشروع الجديد هو تعديل بنود خاصة بعمر وترتيب الحضانة والوصاية على الأطفال والمال والنفس، وقوانين الرؤية والاستزارة، وقوانين الطلاق الشفهي والزواج والتعدد، ومسودة جديدة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وإضافة 4 بنود جديدة متمثلة في وضع نظام جديد يجمع نزاعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وتقصير مدد الفصل في دعاوى الأسرة ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، بالإضافة إلى بند يتعلق بالخطوبة والعدول عنها واسترداد الشبكة.
أولاً: الحضانة والنفقة
نص التعديل الجديد على تثبيت سن الحضانة عند 15 عامًا للإناث والذكور حتى زواج الأم أو وفاتها للمسلمين والمسيحيين، وأن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة. وكان ترتيب الحضانة في القانون الساري يعتمد على ترتيب يشمل الأم في المرتبة الأولى والأب في المرتبة الـ16 والأخيرة، بعد الجدات والأخوات الشقيقات وغير الشقيقات وبنات الأخوات بالترتيب، يليهم الخالات ثم العمات ثم بنات الخالات وبنات العمات ثم بنات الأخ من ناحية الأب بالترتيب، يليهم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأم يليهم عمات الأب بالترتيب. يُعزز التعديل أهمية دور الأب ومسئوليته الأساسية والمباشرة في التواجد في حياة الأطفال بعد الانفصال، ولكن على الجانب الآخر هل يضمن عدم ممارسة العنف النفسي والجسدي ضد الأم والضغط عليها ومساومتها على حق الحضانة والرؤية مقابل تنازلها عن نفقتها الشخصية ونفقة الأطفال بعد الطلاق؟ ففي فبراير 2025 تعرضت سيدة مصرية وشقيقتها للسحل[4] بسيارة طليقها أمام محكمة أسرة السادس من أكتوبر، وذلك أثناء نظر المحكمة دعوى نفقة مقدمة ضده للتنازل عن قضايا الطلاق والنفقة.
والجدير بالذكر أن المحكمة في القانون الساري تطلب من الزوجة تقديم إثبات يفيد دخل الزوج لتحديد نفقة المتعة وأجر الحضانة والمسكن ومصروفات الأطفال، ولكن الواقع أن حوالي 70%[5] من العمالة بين الذكور غير رسمية[6]، مما يجعل أمر الإثبات معقدًا ويظل الحصول على النفقة مرهقًا قانونيًا وعبئًا نفسيًا وماديًا ورعائيًا على النساء لتلبية احتياجات أسرهن، مع غياب آليات الشفافية لتحديد الدخل الفعلي للأزواج. فحتى في حالات إثبات الدخل، فالحد الأقصى لخصم مقدار النفقة من راتب الرجال هو 25% للزوجة أو المطلقة و35% للأطفال[7]، وهي نسبة لا تكفي عمليًا أبدًا لسد الحاجات الأساسية لهم. وفي حالة امتناع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة سواء للزوجة/ المطلقة أو للأبناء يمكن للنساء صرف جزء منه عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، وبحد أقصى 500 جنيه مصري[8]. ووفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين في سنة 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متوسط الأجور للرجال 19 ألف جنيه شهريًا بينما متوسط دخل النساء 3000 جنيه شهريا فقط[9]، مع ملاحظة أن الفئة التي تتقاضى متوسط أجور من 3 آلاف إلى 16 ألف جنيهًا شهريًا ينتمون لفئة الـ20% الأعلى دخلاً من سكان مصر، بينما يتراوح متوسط الإنفاق في فئة الـ60% الوسطى من الدخل بين 333 جنيهًا شهريًا إلى 2083 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى أن نفس الفئة التي تُمثِّل من 60% إلى 70% من السكان يفوق بها عدد الفقراء من النساء عن الرجال طبقًا لأحدث إصدارات مؤشرات بحث الدخل والإنفاق، للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في 2020[10]. وفي تقرير 2024 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، أشارت الإحصاءات أن النساء تحصلن على حوالي 20.9% من الدخل الذي يحصل عليه الرجال[11]، مما يُشكِّل فجوة كبيرة في الأجور. وتقضي النساء المتزوجات سبعة أضعاف الوقت مقارنةً بالرجال في أعمال الرعاية غير المدفوعة[12]، بينما يُنظر إلى الرجال كمعيلين للأسرة، مما يرسّخ التمييز ضد النساء في سوق العمل، حيث يُفضِّل أصحاب الأعمال عدم توظيف النساء المتزوجات والحوامل بسبب التزاماتهن المنزلية. كما ترتفع نسبة البطالة بين النساء إلى 17.7% مقابل 4.9% للرجال[13]، وتتقاضى حوالي 76.7% من النساء المتزوجات العاملات دخلًا أقل من أزواجهن في معظم الأسر التي يعمل بها الزوجين[14]. على الرغم من أن النساء تعول أكثر من ثلث الأسر المصرية[15] وتساهم في الإنفاق أو بأعمال الرعاية غير المدفوعة التي تُقدّر قيمتها الاقتصادية بـ496 مليار جنيه سنويًا- أي ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر[16]. وتفقد الأم حق الحضانة إذا تزوجت مرة أخرى، مما يجبرها على الاختيار بين الزواج أو أبنائها، فيما لا تسقط حضانة الأب في حالة زواجه بعد الأم أكثر من مرة. ورغم أن بعض النساء يعتمدن على الزواج الثاني كمصدر دعم مادي بسبب عدم كفاية النفقة على أطفالهن من الزواج الأول، فإن قوانين الأحوال الشخصية تمنح الرجال حقوقًا أكبر دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية عليهن.
ثانيًا: الوصاية والولاية وإثبات النسب
في مقترح القانون الجديد أصبحت الأم هي الوصي الأول على الأبناء القصّر في حالة وفاة الأب بدلاً عن الجد للأب أو العم كما ينص القانون الساري. وفيما يخص الولاية المتعلقة بالتعليم والسفر والانتقال، لم يستدل عمّ إذا كان هناك تعديلات في مشروع القانون الجديد، حيث ينص القانون الساري بالنسبة للمسلمين على أن الأب في حالة الزواج أو الطلاق هو الولي الأول على الأطفال فيما يخص التعليم والسفر يليه الجد للأب ثم العم، ما لم يوكل الأب الأم أو يتنازل لها بصفة شخصية أو يتنازل لها أحد أقاربه الموكل لهم قانونًا بالولاية عن هذا الحق في حالة سفر الأب أو وفاته. ويمنح القانون للأب الحق في إلغاء هذا التوكيل أو منع الأطفال من السفر، ولا تحصل الأم على الولاية أو الوصاية على أبنائها وإدارة شئونهم وأموالهم أو استخراج أوراق رسمية لهم أو فتح حسابات بنكية بأسمائهم أو إجراء العمليات الجراحية لهم دون موافقة الأب أو وصية له بوصاية الأم الكاملة بعد وفاته إلا بحكم محكمة، حيث يُنظر إلى الأمهات من جانب القانون والعرف الاجتماعي على أنهن يتحملن مسئولية الرعاية المباشرة، بينما ينظر إلى الآباء على أنهم الاكفأ في إدارة الأمور المادية وتربية الأطفال. وقد أطلقت مجموعات من النساء حملات على مواقع التواصل الاجتماعي في 2021 تحت وسم “الولاية حقي”[17]، للتعبير عن معاناتهن من حرمانهن من حقوق الولاية والتمييز القانوني الذي يحرمهن من اتخاذ قرارات حياتية لأطفالهن.
يمنح نفس القانون للزوج حق منع الزوجة من السفر في أي وقت، ولم يُستدل أيضًا على نص تعديله بالضبط في مقترح القانون الجديد رغم أن التصريحات الخاصة بالمسودة تذكر أن هناك مواد مُعدّلة بخصوص حق ولاية الزوجة على نفسها. والجدير بالذكر أنه طبقًا للتشريع القانوني المصري يسمح للنساء بتزويج أنفسهن دون إذن ولي إذا تجاوزن سن 21 عامًا، إلا أن المآذين غالبًا ما يرفضون عقد القران دون حضور الولي خاصةً في الزيجة الأولى. كما أن هذا الحق مُقيّد بشرط الكفاءة طبقًا للعرف الاجتماعي في مصر، حيث لا يحق للأنثى البكر تزويج نفسها بدون إذن ولي من أقاربها الرجال من الدرجة الأولى فتباعًا. ويحق لهذا الولي قانونًا طلب فسخ الزواج إذا رأى عدم كفاءة الزوج من المستوى المادي أو الاجتماعي أو الديني أو النسب، مما يعكس رؤية مجتمعية وقانونية تُعزز الهيمنة الذكورية، ترى أن النساء تابعات للولي قبل الزواج، وللزوج بعده.
وكذلك في حالة توثيق وإثبات نسب الطفل، لم يُستدل على أي تعديلات واضحة بخصوص هذه البنود. ينص القانون الساري أن النسب حق أصيل للطفل، ويترتب عليه حقوق الرعاية والنفقة والميراث، وأن للأم حق تسجيل طفلها قانونًا ولكن بشرط تقديم إثبات العلاقة الزوجية أو بوجود الأب أو أحد أفراد أسرة الأب من العصب كالجد والجدة للأب والعم والعمة في حالة غياب الأب لأي سبب أو وفاته. وتواجه الأمهات صعوبة في تسجيل أطفالهن إذا غاب الأب أو عائلته، مما يدفعهن للجوء إلى القضاء لإثبات حق التسجيل. ويسمح القانون في معظم الحالات بتسجيل الطفل باسم الأم فقط في حالة غياب وثيقة الزواج، لكن دون ذكر اسمها في سجل المواليد، مما يضع الأطفال في حالة تسمى بسقوط القيد العائلي. أما بالنسبة لإثبات النسب ففي حالة عدم اعتراف الأب بالمولود لأي سبب كان- مثل النزاعات الاسرية أو العلاقة خارج إطار الزواج أو الاغتصاب أو في حالات زواج القاصرات غير المسجل قبل بلوغ الأم سن 18 عام- تضطر الأم إلى اللجوء للقضاء للفصل في هذه الحالة. فيشترط القانون وجود علاقة زوجية قبل الولادة بستة أشهر على الأقل، أو إقرار الأب وشهادة شهود، أو سنة من تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج مع وجود وثيقة طلاق أو شهادة وفاة. ورغم إقرار تحليل الحمض النووي (DNA) كوسيلة إثبات للنسب، المحاكم المصرية لا تلزم الأب بالخضوع له، وتعد التحليل مجرد رأي فني يخضع لتقدير القاضي. يفتح هذا الأمر بابًا لاستغلال الأزواج للوضع بتهديد الأم بالتشهير والوصم بالزنا وممارسة العنف النفسي والجسدي والضغط عليها للتنازل عن القضايا، مما يضع الأم في موضع المتهمة ويُعامل الطفل/ة في هذه الحالة كمولود/ة زنا طبقًا للقانون، مما يحرمه/ا من إثبات نسبه/ا للأب إلا بوجود زواج مُوثَّق. ورغم إمكانية إثبات النسب بشهادة الشهود، غالبًا ما تتجاهل المحاكم هذا النهج لصالح إثبات الزواج الرسمي، مما يُحمّل الأم وحدها مسؤولية إثبات النسب، ويتجاهل بشكل تام مصلحة الطفل/ة.
ثالثًا: رؤية الأطفال والاستزارة
نص مقترح القانون الجديد على تعديل كلمة الاستضافة وتغييرها إلى الاستزارة باعتبار أن الأطفال ليسوا ضيوفًا وإنما في زيارة لأحد الوالدين على حسب من يمتلك الحضانة، وأن تكون مدة الاستزارة محددة بحوالي 10 ساعات في الشهر بما يعادل حوالي 15 يومًا في السنة. وإذا امتنع أحد الأطراف عن إعادة الأطفال للطرف الحاضن بعد الاستزارة مباشرةً دون علم وموافقة هذا الطرف يمنع من الاستزارة مرة أخرى. وكانت الرؤية في القانون الساري محددة في أماكن مثل الأندية ومراكز الشباب، لكن في القانون الجديد فتح المجال لأماكن أخرى توافق عليها الدولة أو توفرها، كما أُضيفت الرؤية الإلكترونية سواء داخل أو خارج مصر. وفي حالة عدم التزام الأب بالإنفاق على الأبناء، يجوز للأم تقديم طلب لرفض الرؤية والاستزارة. أما إذا رفضت الأم تنفيذ رؤية الأب في حالة إنفاقه على الأطفال فتنتقل الحضانة منها إلى الأب.
رابعًا: الطلاق الشفهي
في القانون الساري يقع الطلاق الشفهي ويترتب عليه الآثار القانونية دون الحاجة لتوثيقه، وهو ما كان يفتح بابًا للتحايل على القانون من بعض المطلقين فيما يخص نفقة متعة الزوجة ودفع مستحقات الزوجة المالية المُتفق عليها بعد الطلاق حين عقد الزواج وكذلك نفقة الأطفال ورد الزوجة دون علمها وطلبها لبيت الطاعة ورفع دعاوى النشوز لمساومتها على إسقاط حقوقها، وممارسة نوع من الوصاية والترهيب والعنف ضدها، وكذلك حرمانها من ميراث الزوج في حالة عدم توثيق الطلاق أو الرد الغيابي. أما في مقترح القانون الجديد فالطلاق الشفهي يقع لكن لا يعتد به قانونًا إلا من تاريخ إعلام الزوجة رسميًا. ويعاقب الزوج قانونًا إذا لم يوثق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه. وفي حالة وفاة الزوج دون علم الزوجة بالطلاق تظل الزوجة مستحقة لميراثها من الزوج.
خامسًا: الزواج والتعدد والخِطبة
رغم أن التصريحات المتداولة عن مسودة القانون الجديد جاءت على ذكر تعديلات تخص بنود الزواج والتعدد وقضايا النزاع في الخِطبة، لم يستدل على تصريحات رسمية أو أي معلومات مفصلة بخصوص هذه البنود. ورغم أن الإحصائيات تشير إلى أنه في عام 2020 كانت 32% من الزيجات المُوّثقة للرجال هي الزيجة الثانية أو أكثر، وأن 46% من الزيجات الجديدة هي لرجال متزوجين سابقًا مقارنةً بزيجات الرجال الذين لم يسبق لهم الزواج[18]، فضلاً عن الزيجات العرفية غير المُوّثقة، وعلى الرغم من أن عدد النساء في مصر في عام 2024 كان 51 مليون مقابل 54 مليون للرجال[19]، وفي بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مارس 2025 بمناسبة يوم المرأة العالمي يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية، أشار البيان أن وفقا لتقديرات السكان في 1 يناير 2025 ( بيانات أولية) بلغ عدد السكان المصريين بالداخل 107.3 مليون نسمة، حيث مثلث النساء منهم 52.2 مليون نسمة بنسبة 48.6%، وبلغت نسبة النوع 106% أي أن هناك 106 ذكر لكل 100 أنثى[20]، وهو ما يضعف مبررات التعدد بأن عدد الرجال أكثر من النساء أو أن التعدد حسب قول البعض يحد من “عنوسة النساء”، أي عدم زواجهن، في حين أن عدد المتزوجات من الإناث يزيد عن عدد المتزوجين من الذكور بنسب 70.3% و65% منهم على الترتيب[21]. إلا أن القانون الساري يسمح بتعدد الزوجات وفقًا للشريعة الإسلامية، دون اشتراط موافقة أيًا من الزوجات أو وضع قيود فعالة لحماية حقوقهن أو وجود شرط تحقق العدل بين الزوجات وإثبات القدرة المادية كما تنص الشريعة الإسلامية. ويقتصر القانون فقط على إلزام الزوج بإخطار زوجته الأولى عن طريق المأذون، ولكن عقوبات عدم الإخطار ضعيفة وتقتصر على مدة حبس قصيرة أو غرامة مالية يقدرها القاضي، مما يتيح التلاعب بتاريخ الإخطار أو عدم الالتزام به من قبل الزوج، وفي معظم الأحيان لا يتم العمل بها في مصر مقارنةً ببعض الدول مثل تونس وتركيا اللاتي تحظران تعدد الزوجات بشكل كامل، والجزائر والعراق وسوريا حيث يُشترط موافقة الزوجة وتصريح من قاضٍ مختص، فضلاً عن إباحة الزواج العرفي في القانون المصري، مما يمنح الأزواج طريقًا سهلًا للزواج بزوجة أخرى دون علم الزوجة الأولى أو أي من الزوجات الأخريات. وفي ظل غياب الحماية القانونية للزوجة المتضررة من التعدد، يُلزِم القانون الزوجة بإثبات الضرر المادي والمعنوي لوقوع الطلاق، مما يجعل الأمر أعقد لأن عبء إثبات الضرر يقع على الزوجة في إثبات دخل الزوج حتى في حالة وقوع الطلاق ووجوب النفقة. وعادةً ما يُسقط القانون حق الزوجة في دعوى الطلاق بعد عام من علمها بالزواج الثاني. ومن الصعب أيضًا إثبات الزوجة للضرر المعنوي والنفسي، بينما يُبَرر للزوج الزواج بأخرى في حالة إثباته للمحكمة أنه مقتدر ماديًا أو أن الزوجة لا تكفي لتلبية احتياجاته الجنسية أو عدم رغبة الزوج في الطلاق رغم وجود خلافات بينهم. وعادةً ما يُنظر لحق الزوج في التعدد دون أي أسباب أخرى. وفي هذه الحالة تضطر الزوجة للجوء لقضايا الخلع وإبراء زوجها من كافة حقوقها المعنوية والمادية من نفقة المتعة والمسكن والأثاث وأجر الحضانة وجميع الحقوق الأخرى المُتفق عليها حين عقد الزواج، كما أنه بالأساس لا يُلزِم القانون الزوج بتوفير مسكن أو نفقة محددة للزوجة في حالة التعدد.
ويمنح القانون المصري سُلطة مُطلقة للرجال في التعدد دون مراعاة حقوق الزوجات، مما يضعف حماية المرأة واستقرارها النفسي والمادي والسكني. ويتطلب الأمر إعادة النظر في تقييد التعدد أو منعه، كما في بعض دول المنطقة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
سادسًا: لائحة قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين
جاء في تقرير على موقع وزارة العدل بتاريخ 10 فبراير 2025 أنه قد عقدت وزارة العدل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين[22] وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. شارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، وتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. وأكد وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعي فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملاً لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الإجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية. إلا أنه لم يُعلن عن أي تفاصيل بخصوص البنود التي نوقشت في الجلسة.
وطبقًا لقانون الأحوال الشخصية الساري، يخضع المسيحيون في مصر لعدة طوائف رئيسية: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، ولكل طائفة لوائح تُنظِم الزواج والطلاق. ويتم تطبيق هذه اللوائح وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000، بشرط أن تكون الطائفة معترف بها قبل عام 1955 وألا تخالف النظام العام. وتحدد الشريعة الإسلامية نطاق تطبيق الشريعة المسيحية، حيث يعتمد القانون المصري عليها في تعريف ما يمكن تطبيقه من شرائع المسيحيين، مما يقيد احتكام المسيحيين لشريعتهم. ولا يُسمح للمسيحيين بتطبيق شرائعهم إلا في الزواج والطلاق، بينما تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل أخرى كالميراث في حالة رغبة الذكور ألا يرثوا بالتساوي مع النساء او طبقًا لوصية مسبقة، والولاية على المال، والنسب والكفالة والتبني. وينتج عن تشتت الأحكام القانونية بين لوائح الطوائف والقوانين العامة والدستور تضارب في القرارات القضائية وصعوبة في حصول النساء المسيحيات على حقوقهن. وتعاني النساء المسيحيات من تمييز قانوني واضح، حيث تُطبق عليهن قواعد الطاعة الإسلامية، وتُفرض عليهن فترة العدة في بعض الطوائف التي لا تنص عليها. كما أن تغيير الزوج لدينه إلى الإسلام يُخضِع الزوجة لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد يرفض تطليقها رغم الضرر. وبينما تتمتع الكنيسة بسلطة كاملة على عقود الزواج وتصاريح الزواج الثاني للمسيحيين في حالة الانفصال، تُصر الكنيسة على الاحتكام للشريعة المسيحية في مسائل الزواج والطلاق، حيث في بعض الحالات تَحرِم الكنيسة الطرف المتضرر المتقدم بطلب الانفصال من الزواج مرة أخرى فقط لطلبة الانفصال أو التفريق رغم الضرر، حيث يعدد الطلاق في بعض الطوائف المسيحية محرمًا إلا لعلة الزنا. وتعاني النساء المسيحيات في الحصول على الطلاق، حيث تُفرض قيود شديدة وصارمة من الكنيسة في هذه الحالات. ففي عام 2008 تم تقليص أسباب الطلاق لدى الأقباط الأرثوذوكس إلى الزنا فقط بتفسيره المُوسّع- الذي يشمل الزنا الفعلي والحكمي مثل المحادثات والرسائل والصور أو الفيديوهات غير اللائقة- وأحيانًا يقع الطلاق لأسباب روحية ودينية مثل تغيير الملة أو الطائفة أو الديانة. أما الطائفة الكاثوليكية فلا تسمح بالطلاق لأي سبب. وهذا التضييق يجعل الطلاق أمرًا بالغ الصعوبة، ويجبر العديد من النساء على البقاء في زيجات غير مرغوبة رغم معاناتهن من العنف الجسدي والنفسي. ولا يمكن للنساء المسيحيات في مصر اللجوء إلى الخلع كما هو الحال في الشريعة الإسلامية، كما أن تغيير الديانة أو الطائفة لا يضمن لهن الحصول على الطلاق بسهولة. وتضطر بعضهن إلى التحول إلى الإسلام للحصول على الطلاق، لكن العودة إلى المسيحية لاحقًا يعرضهن لمشكلات إدارية وقانونية واجتماعية كثيرة.
ويعكس هذا معاناة المسيحيات بشكل مضاعف، حيث يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي بشكل مباشر وأنواع عدة من العنف مثلهن مثل جميع النساء في مصر، فضلاً عن الحرمان الكنسي في بعض الأحيان والمنع من الزواج مرة أخرى دون وجود حلول قانونية ميسّرة. وتواجه المسيحيات المتزوجات من مسلمين تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا، حيث تُطبق الشريعة الإسلامية على الزواج المختلط، مما يحرمهن من حقوقهن في حضانة الأطفال، والولاية على الأبناء، والميراث شأنهن شأن المسلمات. وفي حالة تحول الزوج المسيحي إلى الإسلام بعد الزواج، يصبح دين الأبناء تلقائيًا الإسلام، ولا يُسمح لهم بتغيير ديانتهم رسميًا لاحقًا. كما تُحرم المسيحيات من الميراث في حالة وفاة الزوج المسلم، حيث لا توارث مع اختلاف الدين من منظور شرعي في القانون المصري، مما يهدد استقرارهن المالي والسكني. ويعكس هذا الوضع تمييزًا مزدوجًا ضد المسيحيات في الزواج المختلط، ويؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأسرية والاقتصادية.
تبيح الشريعة المسيحية التبني، إلا أن قانون الطفل لعام 1996 حظر التبني لجميع المصريين، مما أجبر المسيحيين على اللجوء إلى نظام الكفالة كبديل. ويشترط القانون تطابق ديانة الأسرة الكافلة مع الطفل، لكن معظم الأطفال في دور الرعاية يُعتبرون مسلمين بحكم القانون لأن غالبيتهم في حكم القانون مجهولي النسب، مما يمنع الأسر المسيحية من كفالتهم، ويسمح لهم فقط بكفالة الأطفال من دور الرعاية المسيحية حيث يكون جميع الأطفال معلومي النسب. ويتطلب هذا موافقة الأسرة البيولوجية للأطفال وهو شرط يُصعِّب إجراءات الكفالة في هذه الحالة. ويُقدّر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى يناير ٢٠٢٥ بعدد ١٢٣٢٣ طفلا وطفلة، وإجمالي ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية[23]. في المقابل لم تتمكن سوى أسرة مسيحية واحدة من كفالة طفل مسيحي عمره خمس سنوات في عام 2022[24].
وفيما يتعلق بقضايا الميراث للمسيحيين، ينص الدستور المصري لعام 2014 وقانون 1 لسنة 2000 على خضوع المسيحيين واليهود لشريعتهم في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الميراث. إلا أن المحاكم المصرية لا تزال تُطبِّق الشريعة الإسلامية بموجب قانون المواريث 1944 والقانون المدني 1948 الذين ألزما تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا الميراث على المسلمين وغير المسلمين. وفي حالة ميراث المسيحيين، إذا لم يُجمع الورثة على تطبيق الشريعة المسيحية، أو في حالة رغبة أحد الورثة الذكور بمخالفة الإجماع والاحتكام للشريعة الإسلامية التي تنص أن يرث الذكر ضعف الأنثى، يتم الاحتكام للقانون المصري طبقا للشريعة الإسلامية.
تحديات مقترح القانون الجديد
رغم أن البنود الأساسية المتداولة للقانون تضمنت تعديلات على الولاية على النفس والمال والطلاق والرؤية والنفقة وقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى أنها لم تتطرق إلى بنود مهمة في أيٍ من المقترحات مثل حق المسكن الآمن للنساء والأطفال وقوانين العنف الأسري. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت المادة التي تُلزم الزوج بتوفير مسكن للمطلقة الحاضنة، بحجة أنها تُقيّد حق الزوج في الطلاق وتشكّل تمييزًا بين المالك والمستأجر، ولا يوجد نص قانوني حالي يُلزم المطلق بتوفير مسكن، ويقتصر حق المطلقة الحاضنة على الحصول على أجر مسكن فقط في حال عدم امتلاكها أو أبنائها لمسكن، وفي حالة رفع المطلقة دعوى تمكين من مسكن الزوجية يمكن أن تحكم المحكمة بحق الأم والأطفال في المسكن. ورغم هذا يرفض العديد من الأزواج الامتثال لحكم المحكمة بتسليم الشقة للأم والأطفال، حتى إن الأمر يصل في بعض الأحيان إلى تدمير وتخريب المنزل كاملاً بشكل لا يصلح للعيش الآدمي من جانب بعض الآباء انتقامًا من الأم لرفعها للدعوى. وتشير الإحصائيات إلى أن النساء يمتلكن نسبة ضئيلة تقدّر بـ3% فقط من العقارات مقارنةً بـ97% للرجال[25]. كما أن القانون لا يعترف بمشاركة الزوجة في شراء أو تجهيز منزل الزوجية، على الرغم من دعوة شيخ الأزهر في كلمة بيانه الختامي في مؤتمر التجديد المنعقد في يناير 2020 بإحياء فتوى مبدأ الكد والسعاية[26] بعد انحلال الزوجية بالطلاق أو الوفاة والتي تنص على حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا ويقدر حق الزوجة حسب الفتوى في ثروة زوجها بقدر مال الزوجة المضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه في حالة كان الزوج على قيد الحياة أو كان الزواج قائم أو في حالة الطلاق والانفصال ويكون هذا الحق منفصل عن نفقة الزوجة والأطفال سواء كان الزواج قائم أم لا، وأيضا يكون منفصل عن حقها في الميراث، بمعنى أن يُستوفى حق المرأة في الكد والسعاية من تركة زوجها المتوفى مع قضاء ديونه، وقبل تسليم تركته قسمة الميراث الذي تستحق منه نصيب الزوجة، أي فرض الربع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثمن إن كان له منها أولاد أو من غيرها. وتساهم ضآلة أعداد مراكز استضافة النساء وأطفالهن في صعوبة الأمر فيما يخص المسكن الآمن، وعددهم 8 مراكز لاستضافة النساء في 8 محافظات فقط[27] من أصل 27 محافظة، وتُحدد مدة الإقامة بثلاثة أشهر يطلب فيها المركز عدة شروط هي ان تكون المرأة تعرضت للعنف وأن يكون معها أوراق تحقيق شخصية لها وللأطفال وموجب وثيقة رسمية يثبت الزواج أو الطلاق للزوجة المُعنفة سواء كانت مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري، ووجود إثبات مادي أو مفردات مرتب لتحديد رسوم الإقامة في حالة وجود دخل وهي ربع الدخل الثابت، وهذا طبعًا صعب للغاية في حالة إذا كانت الزوجة مُعنَفة أو غير عاملة ولجئت لإحدى المراكز دون وجود إمكانية لتوافر هذه الشروط أو عودتها لمنزل الزوجية لإحضار الأوراق المطلوبة أو حتى عدم الإمكانية المادية لاستخراج أوراق جديدة. فضلاً أنه لا يُسمح بإقامة الأطفال الذكور فوق سن 12 سنة برفقة الأم في المركز، مما يضع الأم والأطفال في ضغط العجز عن إيجاد مسكن آمن. ويترتب على ذلك عدم توفير الأمان السكني للنساء بعد الطلاق مما يجبر بعضهن على البقاء في زيجات تتسم بالعنف بسبب غياب البديل الآمن.
وقد يصل الأمر لحد القتل، حيث يشير تقرير أممي صادر عن الأمم المتحدة في 2023 أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق على يد الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة.[28] وبحسب تقرير موقع بروموندو والأمم المتحدة للمرأة يرى %53.4 من الرجال أن النساء تستحق الضرب في بعض الأحيان، كما يظن %90 منهم أن النساء يجب أن تتحمل العنف لبقاء الأسرة مترابطة.[29] ويُوفِّر القانون والأعراف المجتمعية في مصر غطاءً للعنف الأسري[30] من خلال عدة مواد تُبرر العنف وتخفف العقوبات على الجناة، وخاصةً الزوج. يسمح القانون المصري للزوج بضرب زوجته كعقاب تأديبي، ما لم يُسبب إصابة جسدية خطيرة. وأيضًا يمنح الزوج حق رفع دعوى زنا ضد زوجته، وتخفَّف عقوبته إذا قتلها حال مفاجأتها متلبسة بالزنا، فيما يسمى بقضايا الشرف. كما يُتاح له التنازل عن الدعوى في أي مرحلة، ما يفتح الباب أمام الابتزاز والتلاعب. لا يُحرم الزوج أو الأب من ميراث الزوجة أو الابنة إذا قتلهما بدعوى الزنا وجرائم الشرف وفقًا للقانون المصري. وتشير الإحصاءات في مصر إلى تسجيل 186 جريمة عنف ضد النساء، منها 50 جريمة قتل خلال شهري يناير وفبراير2022 فقط[31]، وأن 1% فقط من النساء يُبلغن الشرطة بسبب ضعف الإجراءات القانونية ورفض أقسام الشرطة تحرير المحاضر بحجة عدم التدخل في النزاعات الأسرية[32]. وطبقا لآخر إحصاء عن العنف الزوجي أجري في 2014، 43% من النساء[33] المتزوجات تعرضن للعنف النفسي والابتزاز، و32% للعنف الجسدي، و12% للعنف الجنسي أو للاغتصاب الزوجي الذي لا يعده القانون أو المجتمع جريمة من الأساس. ويعتقد 77% من الرجال[34] المتزوجين في مصر أن العنف ضد النساء مُبرر في ظروف عدة تتمثل في حق الزوج تأديب زوجته شرعًا أو بسبب الظروف الاقتصادية، وأن القتل مُبرر في حالة شك الزوج أو الأب في سلوك الزوجة أو الابنة. بينما أشارت إحصائيات وزارة العدل المصرية في الفترة ما بين 2021- 2022 أن عدد قضايا العنف الزوجي على مستوى الجمهورية بلغت 9538 قضية؛ منها 8529 قضية من الزوجات ضد الأزواج بواقع 89.5% من القضايا فيما يخص وقائع العنف المنزلي[35]؛ وأشار تقرير مرصد جرائم العنف 2024، أنه تم رصد 415 جريمة عام 2020، و813 جريمة عام 2021 و1006 جريمة عام 2022، و950 جريمة عام 2023، مقابل 1195 جريمة في 2024 للعنف ضد الفتيات والنساء في مختلف محافظات مصر تم رصدها وتسجيلها[36].
خاتمة
يُبرز قانون الأحوال الشخصية في مصر وجود تمييز واضح ضد النساء من خلال بعض الثغرات القانونية التي ما زالت تحول دون تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين؛ إذ يحد القانون من حقوقهن القانونية والاجتماعية ويكرّس تبعيتهن للذكور. ولتحقيق المساواة في الحقوق والمسئوليات بين الجنسين، من الضروري إجراء إصلاحات قانونية شاملة تضمن الحماية القانونية الكاملة للنساء وأطفالهن في كافة الظروف، وتقتضي بمراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الدين، استنادًا إلى مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، بموجب الدستور المصري لعام 2014 الذي يمنح المحكمة الدستورية العليا صلاحية مراجعة مدى توافق القوانين مع الشريعة، دون تدخل المؤسسات الدينية. مع مراعاة الاعتراف بحقوق أتباع الديانات والطوائف الأخرى وإتاحة تنظيم شؤونهم الشخصية عبر قانون مدني مُوّحد للأحوال الشخصية يحترم حرية العقيدة ويحد من التضارب في الأحكام، ويراعي تنوع المجتمع المصري ويكفل العدالة لجميع أفراده. مع مراعاة وضع النساء في المجتمع المصري والسياق الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق عدالة أسرية حقيقية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدالة نوع اجتماعي تضمن حماية النساء وأرواحهن.
[1] “معضلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر”، الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، 24 نوفمبر 2022. متاح على: https://www.hcsr-eg.org/research-about-the-family-laws-in-egypt/
[2] اليوم السابع، “رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يعلن انتهاء صياغته”، 1 يناير 2025. متاح على:https://tinyurl.com/r6awm5va
[3] اليوم السابع، “ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد”، 1 يناير 2025. متاح على: https://tinyurl.com/4fexfkns
[4] المصري اليوم، “سحل مواطن لطليقته وشقيقتها أمام إحدى المحاكم بالجيزة”، 17 فبراير 2025. متاح على: https://www.youtube.com/shorts/GFbbsf59Bw8
[5] “معضلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر”، سبق ذكره.
[6] حسابات تقديرية بناء على النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2023، إصدار أبريل 2024، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. متاح على: https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&YearID=23620
[7] القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، مادة 76.
[8] صندوق تأمين الأسرة، بنك ناصر الاجتماعي. متاح على:https://nsb.gov.eg/en/expenses/family-insurance-fund/
[9] Global Gender Gap Report 2022, World Economic Forum, July 2022. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf
[10] أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، 2019/ 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ديسمبر 2020. متاح على: https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=23629
[11] Global Gender Gap Report 2022. Ibid.
[12] The Role of the Care Economy in Promoting Gender Equality: Progress of Women in the Arab States 2020, UN Women. Available at: https://tinyurl.com/425ea584
[13] النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2023، سبق ذكره.
[14] المسح السكاني الصحي- مصر 2014، وزارة الصحة، مايو 2015. متاح على: https://www.unicef.org/egypt/ar/reports/egypt-demographic-and-health-survey-2014
[15] معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي طبقًا للسن والحالة التعليمية والأقاليم الجغرافية والنوع، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2023، سبق ذكره.
[16] مسح استخدام الوقت 2015، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، متاح على: https://censusinfo.capmas.gov.eg/metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1338/dataappraisal
[17] “الولاية حقي”، مؤسسة المرأة والذاكرة، 2021. متاح على: https://drive.google.com/file/d/1OGBncO4AYiuzpUE-ye1y137rgRyFrHVB/view
[18] النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أغسطس 2024. متاح على: https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&YearID=23631
[19] “مصر في أرقام- السكان”، إبريل 2024، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. متاح على: https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
[20]بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2025. متاح على: https://www.capmas.gov.eg/Pages/GeneralNews.aspx?page_id=1
[21] الكتاب الإحصائي السنوي– السكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. متاح على: https://www.capmas.gov.eg/pages/staticpages.aspx?page_id=5034
[22] “وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين”، بوابة وزارة العدل، https://moj.gov.eg/ar/News/Pages/2025/20250210.aspx
[23] “وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة”، صفحة وزارة التضامن الاجتماعي على فيسبوك، 24 فبراير 2025. https://tinyurl.com/4arcydee
[24] تجربة أول طفل مسيحي مكفول، 10 يوليو 2022، https://www.facebook.com/KafalaCH/videos/386438710251572/
[25] حسابات تقديرية مستندة على المسح السكاني الصحي لمصر 2014 والتعداد العام للسكان، من “معضلات قوانين الأحوال الشخصية المصرية”، سبق ذكره.
[26] “مركز الأزهر للفتوى يقدم إضاءات حول حق المرأة في الكد والسعاية”، بوابة الأزهر الإلكترونية 2022. متاح على: https://tinyurl.com/4u8x7nxf
[27] “مراكز استضافة المرأة”، وزارة التضامن الاجتماعي. https://www.moss.gov.eg/Sites/MOSA/ar-eg/Pages/WomensHostingCenters-aspx.aspx
[28] “تقرير أممي: امرأة تُقتَل كل 10 دقائق على يد الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة”، أخبار الأمم المتحدة، 25 نوفمبر 2024. متاح على: https://news.un.org/ar/story/2024/11/1136806
[29] Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Study in the Middle East and North Africa, UN Women, 2017. Available at: https://tinyurl.com/2nc7tecu
[30] “عنف الشريك الحميم (الزوج)”، الإنسان والمدينة للأبحاث الانسانية والاجتماعية، سبتمبر 2021. متاح على: https://tinyurl.com/y753mcut
[31] “بيان صحفي عن شهر يناير وفبراير”، مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة. متاح على: https://docs.google.com/document/d/1KzkstfZ4naiOlJNS24OcVWbkGxWPN2lh/edit?tab=t.0
[32] شيماء حمدي، “أروح لمين: مصريات ضحايا العنف الأسري فمن ينصفهن؟”، درج، 28 أبريل 2022. متاح على: https://tinyurl.com/4eazcjrb
[33] مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، 2015. متاح على: https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1336/study-description
[34] “توجهات وسلوكيات الشباب المتزوج نحو العنف الأسري”، مجلس السكان الدولي، 2017. متاح على: https://tinyurl.com/2st7m2t9
[35] “تقارير وإحصائيات المحاكم”، بوابة وزارة العدل. https://moj.gov.eg/ar/CourtsStatistics/Pages/NewsListing.aspx
[36] “تقرير مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر لعام 2024″، مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة. متاح على: https://tinyurl.com/2w9yz9za